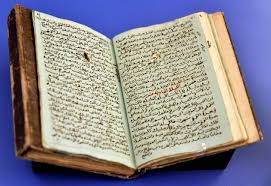
بعد القراءة العالمة التي تحدثت عنها مقالات سابقة، كانت القراءة الجامعة؛ تعلمت معنى القراءة الجامعة بين النصوص من أستاذتي منى أبو الفضل، رحمة الله عليها، وكذا البروفيسور برفيز منظور حينما اتبعا طريقة في الجمع بين الكتب المختلفة في عرض على صعيد واحد؛ فنظم بين المؤلفات الموضوع المتحد، وكأن بين تلك الكتابات حواراً مثمراً ومقارناً من نوع خاص؛ ملاحظة زوايا النظر المختلفة، انفتحت فيه أفق القراءة الجامعة والناظمة والمقارنة في آن واحد؛ وقمت بتجربة ذلك في كتاب تحت الطبع، وخصوصاً في الجزء الثاني منه الذي شكل قراءة منهاجية لنصوص تراثية متنوعة، يجمعها موضوع واحد، العلاقة بين “العالم والسلطان”.
في القراءة الجامعة، نجد الموضوع مناسبة، والنصوص ميداناً للتفاعل معها بقراءة، أو إن شئت الدقّة، بمشروع قراءة، نحاول أن نجمع فيه ونستدعي كل ما يرد على الفكر والتفكير من آليات المنهج في النظر والتناول والتعامل. كطريقة جامعة لكل معاني القراءة المفتوحة الحاوية لعناصر الضبط والتنوّع الذاتي والاجتهاد القرائي في التعامل مع النصوص؛ فماذا عن حقيقة الاختلاف ضمن البيئة المعرفية الإسلامية؟ وماذا عن طبيعة الصور التي يتّخذها؟ وماذا يترتّب على هذه الرؤية في النظر إلى قواعد التعامل وأشكال العلاقات المختلفة؟ المقارنة بين النصوص التراثية بما تقتضيه القراءة المنفتحة ووفق أصول المنهاجية المقارنة؛ وفق جهات الاختلاف وعناصر الائتلاف، وجهات الاختلاف أربع (المكان، والزمان، والأشخاص، والأحوال)؛ وجهات الائتلاف (الاشتراك والتشابه، والتناظر، …)؛ الدراسة وفقاً لهذه العناصر المختلفة وتقاطعها وتفاعلها تحرّك أصول البحث في السياقات المختلفة، والسياق هنا مفهوم متّسع ممتد، منه ما يتعلق بالمؤلف وسياقاته النفسية والسيكولوجية، ومنه ما يتعلق بالنصّ وتتابعاته ومكوناته (مقدّماته وتركيباته ومنهجه، وعباراته)، أي بمعنى السياقات الداخلية للنص، ومنها كذلك ما يتعلق ببيئة النص الخارجية والوسط التاريخي الذي يتحرّك فيه (من زمان ومكان وبشر وأحوال)، وهو كذلك يتحرّك ضمن سياقات أخرى متقاطعة.
في القراءة الجامعة، نجد الموضوع مناسبة، والنصوص ميداناً للتفاعل معها بقراءة
النصوص التبعية في تحليل نص أو أكثر يفصح عن آلية تتمثل في “استدعاء نصوص” لفهم نص أو نصوص؛ نحن هنا أمام آلية غاية في الأهمية تتسع من خلالها دائرة النصوص، سواء تعلق الأمر بالمفكر وحدة للتحليل (أو الفكرة أو النص وحدة التحليل، مع مراعاة الجمع بين هذه النصوص باستخدام آلية المقارنة، والتناص، سواء كان ذلك يعني التعرف إلى النص وفهمه مفرداً أو التعرّف إليه بمعاونة النصوص الأخرى، آلية الجمع بين الآراء كما عبر عنها “ميزان الشعراني” وسعة النص ومسار الشريعة (المتصل الاجتهادي). الجمع بين رؤى مختلفة حيال قضية ما يفرض علينا، في ضوء المنهاجية المقارنة، أن نتحرّك صوب إمكان الجمع بين هذه المواقف والاجتهادات في ما يمكن تسميته المتصل الاجتهادي الذي يسع المواقف والاجتهادات على اختلافها ضمن الجهات التي تؤدّي إلى ذلك من أشخاص، وأماكن، وأزمان، وأحوال. وكذا آلية تكامل القراءات (قراءة الاختلاف، قراءة الائتلاف، الجمع بين القراءات، قراءة الاستثمار والاعتبار)، وهي أصل منهجي يقوم على قاعدة من تكامل القراءات، بحيث يمكننا تصوّر أن هذه القراءات تتحاور، أو تتشاور ضمن قراءاتٍ شوريةٍ يستشير فيها النص غيره، فيستدرك هنا أو يكمل هناك أو يتحفظ أو يخصّص أو يقيّد أو يفصل المجمل. إنها وظائف مهمّة تتحرّك صوب التفسير المدقق الذي لا يعتمد قراءة أولية للنص يتوقف عندها أو ينكفئ عليها. ولعل تكامل القراءات جزء من عمليات التكامل المعرفي والبحثي والمنهجي.
القراءة الجامعة في شكل القراءة المقارنة؛ ذلك أن المقارنة تملك تأثيرات مباشرة في العمليات المنهجية المختلفة، فإنها كذلك تتحرّك صوب تفسير النتائج ذاتها، المقارنة تفتح أفق القراءة، وتحدّد مفاصل المقارنة ومحكّاتها، وتضبط وجهات التفسير، قد تأتي القراءة للنصّ المغلق بنتائج تختلف اختلافاً واضحاً أو جدياً، فإنه بالمقارنة تتضح أوزان التفسيرات وتوجهاتها وهي ضمن هذه المسافات، تحرّر مناطق النزاع إن وُجدت، وتحقق أصول التشابه والاختلاف، وتقوم أوزان النتائج والعلاقات.
إن الرؤية المقارنة تساهم في الكشف عن عناصر قراءة المسكوت عنه داخل النص، خصوصاً حينما يكون الموضوع واحداً
إن الرؤية المقارنة تساهم في الكشف عن عناصر قراءة المسكوت عنه داخل النص، خصوصاً حينما يكون الموضوع واحداً، ويختلف الكاتب في الأداء وفي الهدف وفي المنهج، وفي غير ذلك مما قد تختلف فيه النصوص موضع المقارنة. حينما أشرنا إلى آلية استدعاء النصوص، فربما هنا كنا نقصد “الاستدعاء الموضوعي”، أي استدعاء جملة من النصوص في الموضوع نفسه، إلا أن هذا الاستدعاء يجب ألا يقف عند هذا الحد، بل ربما يتطرّق إلى نوع آخر من استدعاء نصوص، وهو استدعاء نصوص أخرى للمؤلف، يمكن أن تساهم في تفهم رؤيته من خلال النص موضع التحليل.
وفي هذا السياق، فإن مدخل هذه القراءة الجامعة تسوّغه تلك المقولة الناظمة، أن في اختلاف المسالك راحة للسالك وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأرب والتوصل إلى المُراد بفعل تعدّد النصوص ضمن موضوعٍ بعينه يُحسن الوقوف عند هذه القراءة الجامعة، وكل الآليات المنهجية التي يفرضها تعدّد النصوص من جانب، وتوسل المنهاجية المقارنة من جانب آخر؛ وتتحرك هذه القراءة الجامعة في مستويات ثلاثة:
أولها: قراءة الاختلاف، أي جملة الاختلافات البارزة التي يجب أن تتخذ في الاعتبار عند عملية الجمع بين القراءات، وحتى لا تعتبر عملية الجمع قفزاً على جملة الاختلافات وبنياتها وتأثيراتها وضرورة تحرير الاختلاف ومداه وطبيعته، من مثل هل يعتبر الاختلاف مجرد اختلاف ظاهري أم عارض أم متوهم أم خلاف جوهري وحقيقي ومعتبر؟
النصوص التبعية في تحليل نص أو أكثر يفصح عن آلية تتمثل في “استدعاء نصوص” لفهم نص أو نصوص؛ نحن هنا أمام آلية غاية في الأهمية تتسع من خلالها دائرة النصوص
ثانيها: قراءة الائتلاف، أي البحث عن أصول المشترك بين جملة النصوص المختلفة التي تشكل بدورها مداخل مهمة لإمكانات الجمع بين النصوص، لإمكانية الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف من دون أن يكون ذلك اعتسافاً أو تلفيقاً أو توفيقاً من غير شروط منهجية.
ثالثها: وإذا كان المستويان تفرضهما عناصر المنهاجية المقارنة بالبحث في الفروق والاختلافات من جهة والنظائر والمشتركات والمؤتلفات من جهة أخرى، فإن هذا المستوى الثالث ينطلق من هاتين القراءتين، إلى القراءة الجامعة، التي لا تعبر عن مجرد الجمع الميكانيكي بين النصوص، بل جمع يستند إلى أصول منهجية من جانب وتفاعل من جانب آخر، يتحرك ضمن رؤى متعددة ومتعاضدة في سياق القراءة الجامعة وهي تجمع بين هذه النصوص وقراءاتها من أكثر من طريق أو مسلك ما كان ذلك متاحاً أو مستطاعاً.
مستويات ثلاثة مهمّة مرهونة بممارستها المنهجية وطرائق الجمع بين النصوص، ويبقى المتحصّل بعد ذلك محرّراً محققاً محدّداً، يحرّر مناطق الاختلاف، ويحدد مجالات الائتلاف، ويحقق الجمع الواضح بين النصوص ومسالكه. وقراءة الائتلاف والاختلاف على التوازي أو على التوالي من الأهمية نفسها بحيث لا يسرف القارئ في مدخل على حساب الآخر، وتتحكّم فيه فكرة الاختلاف والتناقض والتضاد والتصارع والتنازع، أو تتحكم فيه في المقابل فكرة النظائر والتشابه فيهمل الفروق والمتميزات والمختلفات. إلا أن الواقع أن هناك حالاً ثالثة نخرج منها من الاختلاف إلى الائتلاف. يتحرك صوب هذه المعاني الماوردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين حينما يتحدث أنه “…. إذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً، وبهم من الحاجة الفقر .. فيذهبوا ضيعة يهلكوا عجزاً، وإذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة … وقد قال الله تعالى {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ}{118 – 119]”. والعبارة التي نبحث عنها حتى نتحرك صوب التعرف إلى هذه القراءات “… وإذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة (أي بالتكامل) متواصلين بالحاجة (أي مفتقرين بعضهم إلى بعض)”. بل إن ما نراه من مداخل اختلاف قد تتشكّل ضمن رؤية الائتلاف على مذهب الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف وهو ما نجده ضمن هذه القراءة الجامعة فتجمع وتنظم بين المشترك الكامن في الموضوع الواحد.

