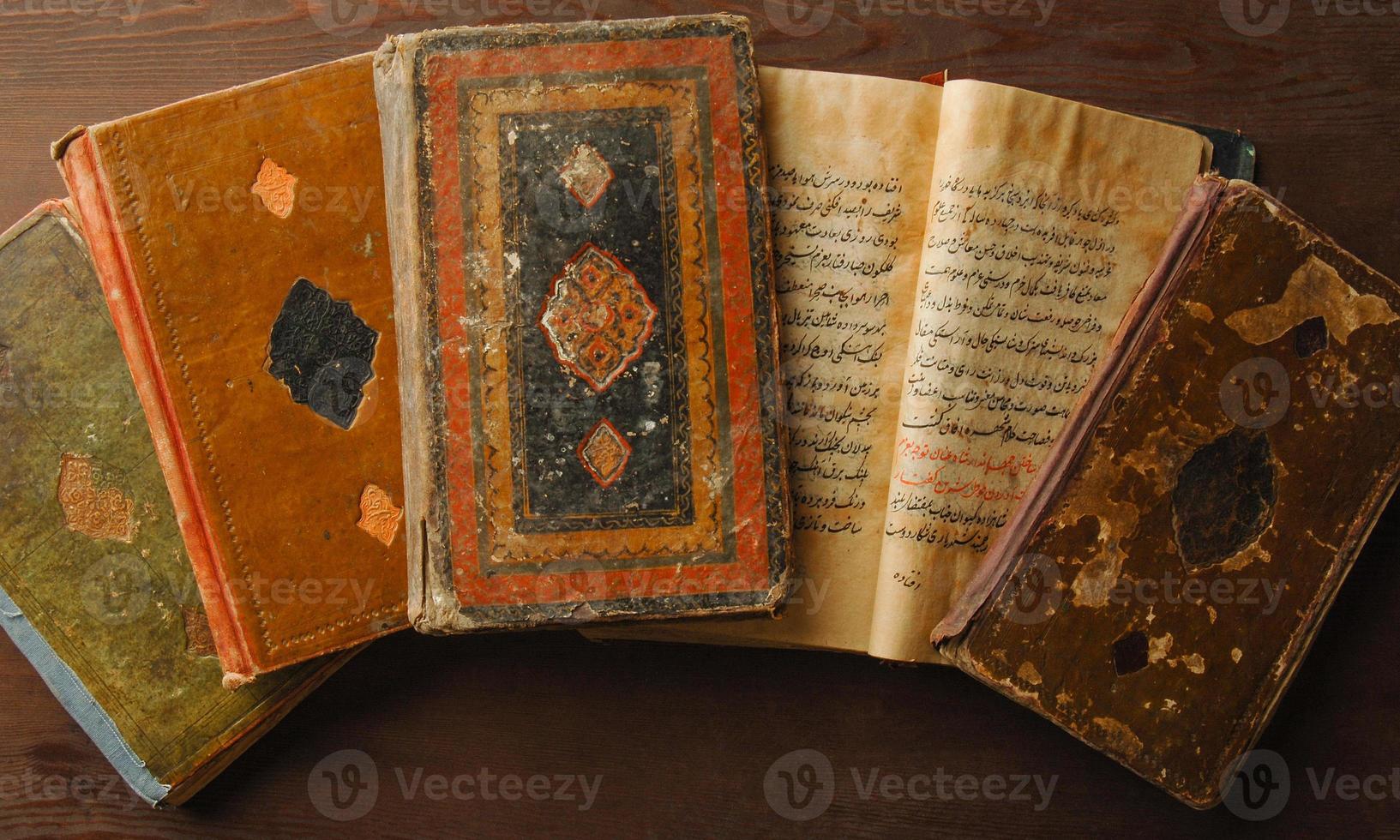
يُقصد بالقراءة العالمة ما يفرضه النص من أصولٍ أولية تعنى بفهمه، أو ما يترتب على ذلك من تأويل، وهي قراءة تحاول التعامل مع المفاصل الأساسية للنص وأفكاره الأساسية، وتستخدم في ذلك آلياتٍ تتفاعل، فتنتج قراءة عالمة بالنص وبنيته وطبوغرافيته وجغرافيّته وبتكويناته المرجعية وذاكرته، بل ومناطق المسكوت عنه. وإذا أردنا أن نتخيّر تسمية لهذه القراءة العالمة فهي التي تجعل التأويل عملية وسيطة بين النص والقارئ، والتأويل كقراءة عالمة هو تفسير ما في النصّ من غموض، بحيث يبدو واضحاً جلياً ذا دلالة يدركها كل الناس، وهو كذلك إعطاء معنىً معيّناً لنصٍّ ما، كما هو الحال في استنباط المغزى أو ما هو في حكمه، وهو أخيراً إعطاء معنىً أو دلالة لحدثٍ أو قولٍ لا تبدو فيه هذه الدلالة لأول وهلة، ويكون غالباً في التأويلات السياسية.
هناك، إذن، قراءة عالمة تتّخذ من التأويل الذي يتمثل في أبعاد عدّة؛ فمن التفسير إلى تحديد المعنى إلى تجاوز دلالة الوهلة الأولى. وأياً كان المستوى، يتأكّد لنا أن التأويل اجتهادٌ فاعلٌ في النص يجلّي غموضه حيناً، ويعيّن معانيه حيناً آخر، أو يستنبط دلالة غير جلية فيه أخيراً، ويعتبر النصّ تواصلاً ينقل فكر المؤلف ورؤاه وانفعالاته إلى المتلقّي، وهو خطابٌ يتشكّل في قلم المؤلف.. عبر حضور المتلقي. ويمكن من خلال النصوص، لغة وبناء ودلالة، تبيّن مثل هذا الحضور. والنص، بصورة أو بأخرى، تكمن خلفه ومن خلاله لكاتبه قراءة للعالم وللحياة يسوقها الكاتب (المؤلف)، ويتجه بها إلى المتلقّي، النص باعتباره خطاباً يحمل تفسيراً للذات وللعالم، وهو تفسيرٌ يعبّر عن فهمٍ أو رفض قبولٍ أو رد.
حول جغرافية النص وطبوغرافيته؛ هذه قراءة واصفة تختلف باختلاف مقياس رسم خريطة النص، وحيث تحدّد الإشارات المنهجية السابقة المسارات المتنوّعة للقراءة والمستويات المتعدّدة لها، فإننا أقرب ما نكون إلى البحث عن المفاصل الأساسية ضمن النص من مكوّنات وبنيات، من دون التتبع المتقصي لألفاظه وعباراته، ذلك أن القراءة التتبعية لا تزال تتطلب سعة أكبر ضمن عمليات تحليل النصوص موضع الدراسة، ولعل ذلك يكون ضمن دراسة أكثر تتبّعاً وأكثر تشريحاً.
وسنحاول ونحن نستعرض المفاصل الأساسية والتضاريس الكبرى للخريطة الفكرية للنص. ولا شك في أن استعارتنا ألفاظاً (مثل جغرافيا، وطبوغرافية، وخرائط) وربطها بالنص من الاستعارات المجازية التي تجعلنا نتفهم النص وحدة تحليل، وتجهيز مادّته الفكرية لإحداث حركة المقارنات بين الخرائط المختلفة للنصوص وما يترتب على ذلك من قراءاتٍ تتعدّد في مستوياتها، إلا أنها تتأسّس على هذه القراءة الأولية الفاحصة للخريطة الفكرية للنص، مستخدمةً عبارات المؤلف إلى حدّ كبير، بما يعين على تسلسله ورؤية تضاريسه الأساسية، وبما تمثله من ذاكرة مكانية للنص، وفى مدخلنا هذا لسبر أغوار النص ضمن القراءات المتعدّدة والبحث عن الدور الجغرافي فيه.
قد يعتبر المسكوت عنه في النص ما هو خفي، بحيث أن خفاءه يجعل من يقرأ النص في حيرةٍ عند تحليل النص وتفهم معانيه
وإذا استعرنا اللغة المجازية، هل تستطيع أن تصوّر “النص التراثي السياسي” بما يمكن تسميته كائناً جغرافياً، له مساحة وحدود وتضاريس وطبيعة معينة تختلف عما سواها من النصوص الأخرى، كما تختلف هذه المساحة نسبة الماء إلى اليابسة، وأن تحدد ما فيها من مرتفعات ومنخفضات وطرق وخطوط طول وخطوط عرض، وأن نتبيّن مناخها بين حارّ ومعتدل وبارد …؟! وفي كل الأحوال، تعتبر خرائط النصوص مدخلا مهمّاً وأولياً لدراسة النصوص وفهمها، وهي أدقّ من هذا متطلب سابق للفهم ومواصلة القراءات في مستوياتها المتعدّدة الأشد تركيباً والأكثر تعقيداً.
ذاكرة النص (السياق والسباق)؛ ذلك لأن لكل نص ذاكرة، وإذا كنّا تحدّثنا عن جغرافية النص وطبوغرافيته لا نستطيع أن نقف عند حدود المشابهة الجغرافية، أو البحث في خريطته الفكرية، لا بد أن نتطرّق إلى ذاكرة النص، والتي تشكّل منظومة سياقاته وسباقاته؛ ويقدّم السياق التاريخي والظروف التاريخية المحيطة بالكتابات التراثية دالة مهمّة في ذاكرة تلك النصوص، تساهم بدورها في التعرّف إلى بنيات النص وتوجّهاته وأغراض كاتبيه، وتفاعلهم بالتأثير والتأثر مع عصورهم؛ وكذلك تقع ضمن هذه الذاكرة سيرة المؤلف.
العبارات المرجعية وتحليل النصوص؛ ذلك أن العبارات المرجعية هي التي تشكّل “إطار المرجع” لكاتب النص سواء مثلت له هذه العبارة مرجعاً فكرياً أو واقعياً أو حكمياً أو موقفياً. وتقوم هذه العبارات بجملة من الوظائف والأدوار من استكشاف موقف صاحب النص تجاه قضية بعينها. إنها، وفق خرائط النص وتضاريسه، أعلى بقعة في النص يستطيع منها الكاتب والقارئ استكشاف الصورة العامة للنص في تضاريسه الظاهرة، ومكنوناته العميقة، وإمكانات النص الفاعلة. ومن ثمّ، هي لا تقف عند حدود وظيفة الاستكشاف، بل هي عبارة مدخل مهمّة تحرك النص نحو وجهاته ومترتباته وعناصره وبنياته ومقاصده وأغراضه. ولذلك هي عبارة مفتاحية تجعلنا ننفتح على كامل النصّ ومكوّناته ومستوياته، وهي تحقق عناصر الاستكشاف والاستدعاء لبقية أفكار النص.
تعتبر خرائط النصوص مدخلاً مهمّاً وأولياً لدراسة النصوص وفهمها، وهي أدقّ من هذا متطلب سابق للفهم ومواصلة القراءات في مستوياتها المتعدّدة
ونظرة على النصوص وجغرافيتها وخرائطها يمكن أن تحدّد هذه “الجمل أو العبارات المرجعية”، وهي تعتبر بالنسبة للمؤلف أو كاتب النص جملاً أساسية، وبالنسبة للقارئ جملاً مفتاحية لفهم النص فهما أوفى. هذه القراءة المفاهيمية يجب أن تتوخّى جملة من العناصر التي تساهم في تصور المفاهيم والموقف منها: المفاهيم وحدات أساسية في التعامل حول موضوع بعينه، هذا الموضوع بطبيعته يستدعي جملة من المفاهيم الأساسية بحيث تكون من مجموعها شبكة علاقات التفسير، وربما متابعة هذه المفاهيم ضمن النصوص موضع التحليل عملية تجد حجّيتها في هذا المقام؛ والنظر إلى هذه المفاهيم على هذا النحو يمكن القارئ (لو أراد) من القيام بقراءة مفاهيمية للنص، ويكون ذلك موضع جهده واجتهاده، وذلك بمحاولة تخريج المفاهيم الأساسية، والمفاهيم التابعة والمفاهيم التي يعتبرها مدخله، أو المفاهيم التي تسند جملة هذه المفاهيم النصّية، وتجليها من خلال النصوص الأخرى. ومن هنا وجب أن تكون هناك دراسة تحليلية مفاهيمية للنص، باعتبارها أحد المستويات المهمّة في رؤية قضية المفاهيم على مستوى منهجي يحرّك التعامل صوب مفاهيم بعينها، وربما قد يُستفاد من الطرائق التي تعرض بها هذه المفاهيم ضمن النصوص التراثية المتنوّعة؛ كما يُلحق بهذا التحليل تحليلاً حججياً، وكذا الكشف عن وسائل الإقناع.
وقد يعتبر المسكوت عنه في النص ما هو خفي، بحيث أن خفاءه يجعل من يقرأ النص في حيرةٍ عند تحليل النص وتفهم معانيه. غير أن بعضهم الذي يتحرك صوب دراسة “المسكوت عنه”، يستغله لتوسيع مساحاته في النص، فالمسكوت عنه نسبة قول لقائل لم يقله، وهو بهذا المعنى قد يكون أحد المداخل التي تتزيّا بثوب العلم “لتحميل النص” أكبر من طاقته في المعنى والمقصود وذلك وفق عناصر تقديرية وذوقية من القارئ للنص. بل قد يكون ذلك مدخلا للتحميل الأيديولوجي للنص في إطار تلوين النصوص ضمن عملية تأويل نظن أنها قد تستخدم هذه الآلية وتسيء استعمالها ضمن تحليلها للنصوص.
وربما المسكوت عنه يفترض عدة تساؤلات والإجابة عنها ضمن المعلومات المتوافرة ضمن صياغةٍ منهجيةٍ لا تعتسف أو ترتكب أياً من المسالك التي تؤدّي إلى تشويه النص. وأهمها ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ كيف؟ وتنظم التساؤلات والإجابة عنها ضمن النص ومقولاته ضمن عملية استدلال منضبطة عن المسكوت عنه. وهو وسط موضوعي يشكّل بيئة النص في محاول لاستنطاق النص بكل فاعلياته وتضميناته، الظاهرة منها والمستنيرة تحت سطح النص أو البيئة المحيطة له. إن تساؤلات من النوع الذي يبحث عن الأسباب الدافعة إلى القول؟ أو عدمه؟ وما هو الذي يريد قوله ولم يقله يجب أن يقترن بفهم من السطور وما بينها وما حولها، إنها القراءة العالمة بكل مستوياتها.

